﴿وَٱصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجۡهَهُۥۖ وَلَا تَعۡدُ عَيۡنَاكَ عَنۡهُمۡ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَا تُطِعۡ مَنۡ أَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهُۥ عَن ذِكۡرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمۡرُهُۥ فُرُطٗا٢٨﴾ (الكهف)
ذكر أهل التّفسير لهذه الآية الكريمة من سورة الكهف سببا لنزولها، وبيّنوا كيف أنّ الله عزّ وجلّ أمر نبيّه بالصّبر على مجالسة الفقراء المعدمين من أهل الإسلام، وردِّ طلبِ كفار قريش، والعرب، واليهود، الذين طلبوا منه صرفهم، احتقارا لهم، حتى يجالسوه ويستمعوا منه. وكان ردّ الله عزّ وجلّ واضحا، يأمر نبيّه الكريم بالصّبر على مجالستهم، وعدم الاهتمام بغيرهم من وجهاء العرب وأشرافهم. بيد أنّني كلّما مررت بالآية الكريمة انتابني إحساس قوي أنّها موجهة إليّ، وإلى سائر المسلمين في كلّ الأزمنة. وأنّها وصية الله عزّ وجل الغالية، التي نكرّر قراءتها كلّ جمعة، ونحن نستعد للصّلاة. إنّه إحساس يزداد قوّة مع كلّ كلمة من كلماتها،
حينما أضعها في سياقنا الحاضر، في صلب ما نُعايشُه ونُعانيه اليوم. فنسمع ربِّنا يقول لكلّ واحد منا: ﴿وَٱصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجۡهَهُۥۖ ﴾، وكأنّه يختار لنا الرّفقة التي يجب أن تكون لنا في هذا الظّرف الذي نعرف تحلّله، وتفشي الفساد فيه.
وهي رفقة من خصائصها أنّها تدعو ربها غدوة وعشية، يبدأ يومها بالدّعاء ويختم بالدّعاء، فلا تغفل عن صلتها بربّها، ولا ينقطع تواصلها به صباح مساء، إنّها رفقة تأخذ حظّها من الحياة عملا وضربا في الأرض، ولكنّها على صلة مستمرّة بربّها طوال يومها، ذكرا ودعاء. ثم يأتي الشّطر الثّاني من الوصية الغالية: ﴿ وَلَا تَعۡدُ عَيۡنَاكَ عَنۡهُمۡ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ ﴾، وبعد الأمر يأتي النّهي. نهيٌ عن عدم تجاوز هذه الرّفقة في أحوالها ومعاشها، إلى آخرين ألبستهم الحياة زينتَها التي ستزول عنهم سريعا، كما ألبس الرّبيع الأرض خضرةً وزهورا، سرعان من يعتريها الذّبول، فإذا هي حطام تذروه الرّياح. ثم يأتي الشّطر الثّالث من الوصيّة، غير أنّه الشّطر المهمّ والخطير في الوصيّة كلّها: ﴿ وَلَا تُطِعۡ مَنۡ أَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهُۥ عَن ذِكۡرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمۡرُهُۥ فُرُطٗا﴾ ينهاني فيه ربيّ عن اتباع لون من النّاس، يظن أنّه فهم الحياة، وأدرك معارفها وأسرارها، وأنّه على بيِّنة من أمره في سيره واعتقاده، يستند في ذلك إلى ما بناه له هواه من اعتقاد، وما زيَّنته له نفسه منهج، وما حسّنه له عقله من سبيل، وما حاكه له خياله من تصور، ويريد أن يحمل الآخرين عليه، في كتبه، وخطبه، ومداخلاته.
هذا النّوع من النّاس، يصفه الله لي بأنّه ) أغفل قلبه) وأنّه (اتَّبع هواه( وأنّ نتيجة ذلك كله أنْ )كان أمرُه فُرُطا(، وهي صفات إن نحن عرضناها على رجال الفكر والسياسة والفن في زماننا، وجدناها تخصّهم، وتصدُقُ في وصفهم، وتكشف حقيقَتهم، وتفضح خرابهم. فالقلب غافل عن خالق هذا الكون ومبدعه ومدبّر أمره، والنّفس يقودها هواها، وليس لها من حاد يحدوها غير نزواتها، وظنونها، وشهواتها. وهو وسط كلّ ذلك في دوامة أحواله، وأفكاره، ومساره، كالعقد الذي انفرط سلكه فتناثرت حبّاته في كلّ مكان، وجرت في كلّ اتجاه. لا يقدر على جمعها، ولا على نَظْمِها من جديد ضياعا وضلالا.
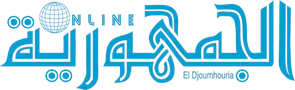




أكتب تعليقك