قال الرازي رحمه الله، في مفاتيح الغيب: (اعْلَمْ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى لِسَانِي فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ أَنَّ هَذِهِ السُّورَةَ الْكَرِيمَةَ يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَنْبَطَ مِنْ فَوَائِدِهَا وَنَفَائِسِهَا عَشَرَةُ آلَافِ مَسْأَلَةٍ، فَاسْتَبْعَدَ هَذَا بَعْضُ الْحُسَّادِ، وَقَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْجَهْلِ وَالْغَيِّ وَالْعِنَادِ، وَحَمَلُوا ذَلِكَ عَلَى مَا أَلِفُوهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مِنَ التَّعَلُّقَاتِ الْفَارِغَةِ عَنِ الْمَعَانِي، وَالْكَلِمَاتِ الْخَالِيَةِ عَنْ تَحْقِيقِ الْمَعَاقِدِ وَالْمَبَانِي.) كلمة تجعل الرّازي رحمه مُتقدّما على عصره، يتلمّس بحسّه اللّغوي والمعرفي الكمَّ العلمي الهاجع في فاتحة الكتاب. وكأنّ الله عزّ وجلّ ما جعلها فاتحة للقرآن الكريم، إلاّ لأنّها بهذا الاكتناز العجيب الذي يجعل المتدبر لكتابه الكريم، مضطرا للبدء بالحمد. كلمة تخرج من أعماقه صادقة وهو يستعرض على نفسه وعقله وقلبه موجبات الحمد. كالذي يتنفس عميقا قبل أن يقول: (الحمد لله(.
ليس هناك مقدمات تستعرض موجبات الحمد، غير كلمة تنطلق من أعماق النّفس لتقول صادقة (الحمد لله). وكأنّ مسافة الانطلاق لم تكن من الإقبال على السّورة تلاوة، وإنّما كانت قبلها بمسافة كبيرة. جال فيها النّظر في أطراف الخلق، مُنطلقا من الذّات إلى المحيط الذي يكتنفها. وشاهدت من آيات الله العجيبة ما جعلها في لحظة إيقانها بحضور الخالق فيها صنعة، وإبداعا، وتسخيرا، لا تجد غير أنّ تقول: الحمد لله. الحمد لله على أنّ لهذا الكون خالقا أوجده من عدم، ونظّم شأنه، وسخّر ما فيه لعباده. وصار مع ذلك كلّ تدبر في أطراف الخلق، وأشكاله، ومنافعه، من هذه المشكاة، لا يجد له المتأمِّل من مقابل في نفسه، وعقله، وقلبه،إلاّأنّ يلهج بالحمد.
وحقيقة الحمد تتجلّى في وحدانية الخالق، الذي أبدع في خلقه، تقديرا، وهداية، وتسخيرا. فقد قال عن ذلك في سورة (الأعلى) ( اَ۬لذِے خَلَقَ فَسَوّ۪يٰ (2) وَالذِے قَدَّرَ فَهَد۪يٰ (3)) وأشار إلى أنّ التّسوية، تنصرف إلى الأشكال، والأحجام، والهيئات، وأنّ الهداية تنصرف إلى الوظيفة والمهمّات. فيكون التّناسب بين هذه وتلك من حقيقة التّجانس والكمال في المخلوق. والنّاظر إلى النّملة والنّحلة، والطّير والدّواب، والفيروس والبكتيريا، والذرة والأجرام، يرى بأمّ عينه كيف يتجانس الحجم والشّكل مع الوظيفة التي أوكلت له. هذه التّسوية، وهذه الهداية، لا تتأتّى على هذا النّحو المعجزإلاّ مع التّوحيد. أيْ كون الصّانع واحداً لا يشاركه في صنعته مبدعٌ آخر، إلاها أو غير إلاه. لأنّ المشاركة تقتضي أن يدخل النّقص من ناحية الشّريك، حتى وإن زعم المشارك أنّه مساوٍ لله عز وجلّ والعياذ بالله. فقد قال تعالى وهو يتحدّث عن إدارة السّماوات والأرض:( لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إلا اَ۬للَّهُ لَفَسَدَتَاۖ فَسُبْحَٰنَ اَ۬للَّهِ رَبِّ اِ۬لْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَۖ (22)) كما كانت الإشارة واضحة في سورة (الكهف) على أنّه لم يستعن بأحد من خلقه، فقال:(مَّآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ اَ۬لسَّمَٰوَٰتِ والأرض وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ اَ۬لْمُضِلِّينَ عَضُداٗۖ (50)).
إنّنا حين نتأكّد أنّ الله الخالقُ المبدعُ، قد أنجز هذا الكون وحدَه، وأنّ هذه الواحدية هي التي أعطت لهذا الخلق منتهى الكمال، والجمال، والتّناسق، لم يعدْ أمامنا إلاّأنّ نُخرج من أعماق صدورنا (الحمدُ لله). والذي يتلو القرآن الكريم حين يبدأ الفاتحة ويكون قد استحضر في نفسه، وعقله،كلّ الحقائق المتعلقة بذاته خلقا وتكوينا، وبما يحيط به من مخلوقات إيجادا وإرشادا، يرى في نفسه أنّه هو الآخر خلقٌ ضمن هذا الإبداع الذي يستوجب الحمد. فيرى في كلّ شيء من حوله داعٍ يدعوه لأنّ ينطق بالحمد صادقا.
إنّ النفس التي تتيقّن أنّها في توحيده الله عزّ وجلّ قد غنمت هذا الوعي الذي يجعلها تعي أنّها من جملة الجمال الذي يصنع الكون، وأنّها هي وأخواتها من مخلوقات الله عزّ وجلّ، تندرج ضمن كينونةٍ ليس لها من حقيقة وجودٍ إلاّ عبادة الله وحمد وشكره، فإنّها ستدرك أنّ قضية التّعبد لم تعد بالنّسبة لها أمرا طارئا عليها، مرغمة على الالتزام به، خوفا من عقاب، أو طمعا في جزاء. بل إنّ التّعبد فيها فطرة تتحرك مع الحمد والشكر، لأنّها جاءت هي الأخرى من (سوّى) و(هدى) وإنّ النّاظر إليها كغيرها موقوف على التّسبيح موفّق إليه بحمد الله عزّ وجلّ.
فالحمد لله، ليس كلمةً تُقال حينما نقرأ الفاتحة، وإنّما شعور يخرج من أعماق الصّدر إيقانا بأنّ وجود الله عزّ وجلّ مغنمٌ للإنسان، وأيّ مغنمٍ. وأنّ حضور الله في خلقه حفظ، وكمال، واستمرار، وبركة.. وما شئنا من صفات نجزيها بين أيدينا للتّعبير عن ضرورة وجود الله في كون يشهد له المؤمن والكافر بالجمال، والتّناسق، والقوّة. هذا الاعتراف الذي يأتي من المنكرين يُقوِّي يقين المؤمن، ويدفعه نحو الحمد. لأنّ المُعاند لم يجد عبر الأزمنة والعصور ما يبرِّر به إنكاره، وما يُفسر به عناده. والمؤمن يسهل عليه أن تكون أول كلمة يفتتح بها لقاءه مع كلام ربِّه هي كلمة الحمد.
والآية على قصرها واقتصادها اللّغوي، استطاعت أن تضع في ظرفها أربعة أسماء من أسماء الله عزّ وجلّ. اسمان وصفتان. وكأنّها توحي إلى القارئ بهذا التّوازي والتّعادل الذي يعطي للحمد حقيقة كونه ابتداء، وجدارةَ تصدُّره الفاتحةَ. فنحن أمام الاسمين: الله، والرّحمان، وأمام الصّفتين: ربّ العالمين، والرّحيم، ننظر في هندسة توزيع الاسمين والصّفتين، نشعر أنّ الله عزّ وجلّ يوجّهنا إلى ذلك، حتى يتقرّر الحمد في قلوبنا وعقولنا، على أنّه ضرورة عبادية أولى، يستوجِبُها التّوحيد ويدعو إليها.
إنّ الانتقال من الاسم إلى الصّفة على هذا النّحو في الآية الكريمة: (اِ۬لْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ اِ۬لْعَٰلَمِينَ (1)اَ۬لرَّحْمَٰنِاِ۬لرَّحِيمِ (2)) يجعلنا نعي جيدا أنّ الحمد يتكرّر مرّات، في كلّ آية من آيات الفاتحة، وكأنّه يسبق كلّ آية ويمهد لما فيها من علم وخير. فنحن نقول: (الحمد لله رب العالمين) ونقول: (الحمد للرّحمن الرّحيم) و(الحمد لمالك يوم الدين) وهكذا.. يتكرّر الحمد في أعماقنا لأنّنا في كلّ وصلة من الوصلات نجد أنفسنا مضطرين اضطرارا جميلا لأنّ نكرّر في أعماقنا هذا الحمد الذي نشعر أنّنا في حاجة ماسّة إليه، وأنّ حياتنا لا تستقيم إلاّ به. والسّر في ذلك أنّنا نحمد الله الخالق الذي أوجد الخلق كلّه.ثم يلتفت بنا إلى صفة من صفاته تتولّى شأن الخلق تدبيرا وتربية، وعناية، وتلك هي صفة الرّب. والرّبوبية في حقيقتها تقتضي التّصريف، والتّدبير، والتّزكية. والله عزّ وجلّ يدير شأن الخلق بهذه الصّفة تربيبا.
أما الحمد المقرون بالرّحمان اسما والرّحيم صفة، فإنّه يُلفتنا إلى حقيقة أخرى تتعلّق بعلاقة الله عزّ وجلّ مع خلقه. فهو إذ خلقَ لم يترك الخلق لشأنه، وسُنَنِه، وقوانينه التي أودعها فيه. كما يزعم بعض المتنوِّرين. بل بسط على خلقه رحمةً تتساوى في أقساطها الخلائقُ كلُّها، فليس هناك من مخلوق إلاّ وقد نال حظه من تلك الرّحمة، مؤمنا كان أو كافرا. وذلك عدلُ الله عزّ وجلّ، لأنّه خلق. ومادام قد خلق، فمن عدله أن ينال الخلق أثرا من رحمته يجريه ويبقيه إلى أجله. أمّا الصّفة (الرّحيم) فهي من كرم الله عزّ وجلّ للذين آمنوا به من خلقه. فهو زيادة على كونه قد بسط عليهم من رحمته الأولى، يُضفي عليها رحمة أخرى في الدّنيا والآخرة. وهذه رحمة خاصّة. رحمة العطف والودّ. رحمة القبول والرّضى.
لم تعد كلمة (الحمد لله) في مطلع الفاتحة مجرد كلمة يقولها القارئ ليبدأ بها تلاوته، وإنّما صارت كلمة يختم بها القارئ معرفته بالله عزّ وجلّ. فهو إذْ عرفَ الله عزّ وجلّ، ورأى من آيته، وجماله، وقدرته، وإبداعه، وتسخيره... ينطق بالحمد، ويجدّده في كلّ آية وكلمة.
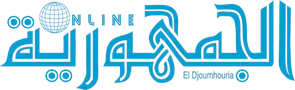




أكتب تعليقك